لفنون البصرية بين المحاكاة والذاتية.. تطور فكري وفلسفي
المصدر: الراية
10 / 09 / 06
فكري كرسون
مرت الفنون البصرية بعدة مراحل أطولها ما تم الاعتماد فيه علي نقل الطبيعة وتسجيلها من عصر الكهوف التي كانوا ينقلون الطبيعة إلي حوائطها كي يتعايش قاطنوها مع ما حولهم، وحتي القرن العشرين، عصر انقلاب المفاهيم وإقرار مفاهيم جديدة، الذي وافق عصر الاكتشافات والاختراعات الحديثة، والنظريات العلمية التي قلبت المفاهيم رأساً علي عقب.
استمر الفن التشكيلي خلال عصور الفن المختلفة، ولمئات السنين لغة بصرية تعتمد في الأساس علي الطبيعة الخارجية كمصدر ومرجع للأفكار الفنية التشكيلية، وكتقليد ثابت وموروث تقاس جودة الأعمال الفنية بالاقتراب منه، وتوصف بالضحالة كلما ابتعدت عنه.
حتي أنه وصل إلي تقليد ونقل غاية في الدقة والإتقان المذهل لتفاصيل الموجودات،كما يظهر بوضوح في أعمال فناني ما قبل القرن العشرين من إبراز لأدق صغائر الأشياء، مثل نسيج الأقمشة وتفاصيل الأرض والسقف وتجاعيد الوجه وخصلات الشعر وملامس المعادن والأحجار وغيرها. وربما يظهر ذلك بوضوح في أعمال فنانين مثل: هانز هولبين (1497 - 1543) و فرانز هالز (1580 - 1666) وحتي بعدها بقليل مع فانسنت فان جوخ (1853 - 1890) صاحب المدرسة التأثيرية التي لم تخرج من إطار الفن كتقليد يستلهم لوحاته من نماذج موجودة أمامه في الطبيعة: كلوحة غرفة نومه و عباد الشمس و الحقول المختلفة و صوره الشخصية وغيرها...
كانت الطبيعة إذن هي الأم والمصدر والرحم الذي أنتج أفكار اللوحات التشكيلية في تلك الفترة وبخاصة قبل اختراع الكاميرا الفوتوغرافية، التي ساهمت بدورها في الانقلاب علي التسجيلية الواقعية.
هكذا كان فنان تلك العصور يعتقد بأن الحقيقة الفنية موجودة خارج كيانه الإنساني.. فهو يبحث عنها ويكتشفها ويسجلها كحقيقة بصرية لا تخطئها عين المتلقي.
ووصلت تلك الحقيقة البصرية إلي ذروتها بوصولنا إلي عصر النهضة الإيطالية فتكشفت قواعد المنظور والظل والنور وبدأت اللوحات تظهر ثلاثية الأبعاد. ومن شهود هذا العصر الفنانين: مايكل أنجلو (1475-1564) و ليوناردو دافنشي (1452-1519) و رامبرانت (1606-1669) وغيرهم.
وبالرغم من ذلك لا يمكن لأي متأمل أن يدعي أن تلك الأعمال كانت خالية من الإبداع لمجرد كونها أعمالاً تسجيلية لحقائق بصرية. وإنما بوسعنا أن نقول أنها كانت أعمالاً فنية طغت عليها الحرفة والتقنية فأبعدت الفنان عن حريته التشكيلية وسجنته في قالب من القواعد والأصول الرصينة والألوان المحددة والمتوارثة من الأساتذة السابقين بتعليمات لا يسمح فيه للتلاميذ بالإبداع، وإنما الأصل بان يلتزم التلميذ بالمنهج الأكاديمي لإبراز الحقيقة البصرية الواقعية للحياة كما لو كانت صورا فوتوغرافية.
خلاصة القول أن الفن كتقليد كان يعني محاولة محاكاة المرئيات في العالم الخارجي والنقل الأمين لتفاصيلها.
وبالوصول إلي مشارف القرن العشرين بدا للفنانين حقيقة جديدة وهي أن ريشة الفنان حينما تسجل الأشياء بالعين دون الوجدان فإنها حتما تنتهي إلي مجرد عملية تسجيل تتفوق عليها الكاميرا وآلة السينما بلا منافس.
وحيث أن الفنان هو في الأصل إنسان لديه مشاعر ووجدان وردود أفعال ومواقف متباينة فقد أصبح يعتمد علي ذاتيته واعتبرها أساساً جديداً ومنهلاً صادقاً في التعبير والإبداع في الفن التشكيلي.
وبعد أن كانت اللوحة هي لقطة واقعية أصبحت فكرة انطباعية .
وبعد أن كانت رؤية بصرية أصبحت رؤية وجدانية .
ويستدل علي ذلك بتجربة قام بها الباحثون علي رسوم الأطفال:
فقد وضعوا طفلا أمام أطفال آخرين في سن الثانية عشرة ليرسموه فلم يهتموا إلا بالانطباع الأولي دون تدقيق ولوحظ أن عددا كبيرا منهم اخذوا يرسمون من عقولهم وعند تحليل ما رسموه وجد أن عددا منهم رسموا زميلهم واقفا مع انه كان جالسا ورسموه أيضا بوجه جانبي إلي اليسار وآخرون رسموه بوجه جانبي إلي اليمين والرسوم في مجملها غلب عليها الطابع الرمزي أكثر منه الواقعي.
وبدا أن ما رسمه كل طفل هو في الحقيقة المضمون الفكري والوجداني كما يظهر في مخيلة كل منهم، وهو ما يطلق عليه منطق الإدراك الكلي .
وهذا المبدأ مطبق بوضوح في الفن المصري القديم - والفن الفارسي - والفن المكسيكي القديم.
وقد بدأ الفن الحديث في القرن العشرين باعتناقه كمدخل لكشف الحقيقة الفنية من منظور جديد.
ودعنا نتصور مغذي الحقيقة الفنية المبنية علي الإدراك الحسي البصري وتلك المبنية علي الإدراك الكلي.
لو رسمنا مثلا المنضدة :
فإذا رسمناها وفقا للإدراك البصري فسيظهر سطحها العلوي ووجهيها الأمامي والجانبي، أي ما نراه حين نطبق قاعدة المنظور.
أما الطفل حين يرسمها بإدراكه الكلي فسوف يجمع بين السطح والجوانب المختلفة والأرجل الأربعة في صورة واحدة. وبحسب منطقه هو انه يرسم المنضدة بشكل أكثر شمولا كما يراها حين يتحرك حولها..لأن الحقيقة لديه قد برزت متعددة الجوانب وكلها صحيحة.
ولهذا تحرر الفنان بيكاسو من الإدراك الحسي البصري في رسمه للوجه من زاوية واحدة، فرأيناه يرسم الوجه من أكثر من زاوية الأمام والجانب في آن واحد، وكانت تبدو هذه المحاولات غريبة وصادمة حين بدأها خاصة لأولئك الذين تعودوا علي الإدراك الحسي البصري. وربما أنه من هنا قد بدأ التمهيد للتحول إلي الرمزية في الفن التشكيلي. وبرز هنا التضارب بين ما يسمي الحقيقة البصرية و الحقيقة الفكرية .
فالأولي ترتبط بميكانيزم الإدراك البصري (ما تراه عيني) والثانية تتعلق بالأفكار (ما يراه وجداني وعقلي). والفرق بينهما كبير.. فالأولي مقيدة.. والثانية محررة. الأولي منقولة.. والثانية مؤلفة.
الأولي ملتزمة بالأصل.. والثانية تحمل الإبداع.
ولعلنا نصل بهذا التصور إلي أن القرن العشرين قد اتجه إلي الحقيقة الفكرية أكثر من اتجاهه إلي الحقيقة البصرية التي قتلت بحثا وتمحيصا وتسجيلا خلال العصور السابقة. أي إلي المفهوم أكثر من الملموس . وبرزت هنا المدارس التي تدعو إلي الرمزية والتجريبية و التجريدية و الخداع البصري و التكعيبية وغيرها من المدارس الفنية التي قامت علي أبجدية حديثة للمفاهيم والأفكار والمشاعر وبعيدا عن الأبجدية القديمة للمرئيات والمدركات الحسية الملموسة.
نرجو أن يكون هذا التوضيح حقق الغرض لمن كتبوا لنا أكثر من مرة يطلبون تبسيط مفهوم الفن وتاريخ تطور آلياته، وهم بالتأكيد من محبي الفنون، وليسوا ممن درسوها، لأن ما تم الإشارة إليه من البديهيات المعلومة عند الدارسين.
المصدر: http://www.alzawraa.net/home/index.p...261&Itemid=229
__________________________________________
الحداثة في الفن
لايمكن اعتبار الحداثة قطيعة أولية لا مثيل لها. ذلك أن حرصها الجنوني على ردم التقليد السائد وتحقيق التجديد الجذري جعلها تساير - في نطاق النظام الثقافي وعلى مدى قرن فاصل - النتاج الخاص للمجتمعات الحديثة، التي ترمي إلى أن تؤسس نفسها على ضوء معطيات النمط الديمقراطي.
ومن ثم، فإن الحداثة لا يمكن أن تكون شيئا آخر غير تعبير عن النسق القديم الذي يؤدي إلى بروز المجتمعات الديمقراطية القائمة على سيادة الفرد والشعب، والمتحررة من سيطرة تراتبيات المجتمع الموروثة وكل تقليد سائد.
وبإمكاننا أن نقف على الاستمرار الثقافي لهذا النسق فيما ظهر بوضوح إبان نهاية القرن الثامن عشر من تحولات على مستوى الممارسات السياسية والتشريعية عملت على إنجاز المشروع الثوري الديمقراطي الذي أدى إلى بناء مجتمع منسلخ عن كل مسوغ مقدس، بحيث يبدو هذا المجتمع في النهاية مجرد تعبير خالص عن إرادة الأفراد ومساواتهم في الحقوق.
وهكذا، اضطر المجتمع إلى أن يبتكر نفسه، من جهة إلى أخرى، حسب الباعث الإنساني لا حسب ميراث الماضي الجماعي، إذ ما عاد أي شيء مقدسا، وإنما ينحاز المجتمع إلى امتلاك حق التصرف والتوجه من ذات نفسه دون ضغط خارجي أو تمشيا مع نموذج يتجلى مطلقا.
ومجاراة للدقة، ألا يمكن القول بأن إلغاء ظاهرة استعلاء وتفوق الماضي هو ما ينطوي عليه عمل المجددين في ميدان الفن؟ فكما أن الثورة الديمقراطية تحرر المجتمع من قوى اللامرئي ومن علاقته بالكون التدريجي، فإن الحداثة الفنية تسعى إلى الغاية نفسها حينما تحرر الفن والأدب من عبادة التقليد الموروث، واحترام الأساتذة الأولين وكذا من نظام التقليد.
ففي نطاق سعيها إلى تحرير المجتمع من عبودية القوى المؤسسة الخارجية واللاإنسانية، وتخليص الفن من قواعد السرد المجسد كان نفس المنطق يعمل عمله ليؤسس نظاما مستقلا لا ركيزة له سوى الفرد الحر.
وكما قال أندريه مالرو: «فإن ما يبحث عنه الفن الجديد هو قلب علاقة الشيء باللوحة وجعله تابعا لها بصورة جلية»، وبالتالي، فإن غاية الحداثة هي «التركيب الخالص» (كاندنسكي) والارتقاء إلى عالم من الأشكال والأصوات والمعاني الحرة والسامية التي لا تخضع لقواعد خارجية سواء كانت دينية أو اجتماعية، بصرية أو أسلوبية.
ودون أن تكون في حالة تعارض مع نظام المساواة، فإن الحداثة هي - عبر وسائل أخرى - استمرار للثورة الديمقراطية ولعملها الرامي إلى تحطيم الأشكال التابعة. وبعبارة أخرى، فإنها تسعى إلى تأسيس فن منسلخ عن الماضي ومستقل بذاته، مما يجعلها تبدو أحيانا عبر بعض صفاتها «النخبوية» فنا منفصلا عن الجماهير و«نسقا تجريديا من وجهة نظر ماركسية» كما أكد ذلك أدرنو.
إن الحداثة ذات جوهر ديمقراطي لأنها لا تفصل الفن عن التقليد والاقتداء، كما أنها تطلق - على غرة - حركة نسق مشروعية سائر المواضيع .
لم يعد للفن موضوع متميز، كما أنه لم يعد يُجمِّلُ العالم؛ إذ بإمكان النموذج أن يكون نحيفا لا قيمة له، كما أنه بإمكان الأفراد أن يتزينوا بسترة سوداء قصيرة وطويلة، وأن توازي طبيعة ميتة رسما لتصبح بعد ذلك خطاطة إجمالية للوحة.
وهكذا، صار التوهج السابق للمواضيع لدى الانطباعيين يفسح المجال لألفة مناظر ضواحي المدينة ولبساطة حافات الطرق والمقاهي والأزقة والمحطات. أما التكعيبيون، فإنهم سيدمجون في لوحاتهم الأرقام والحروف وقطعا من الأوراق والزجاج والحديد. وعبر حضور الجاهز - وكما يقول الرسام دوشان فإنه من الأهمية أن يكون الشيء المختار تافها بصفة مطلقة.
ولقيامه بذلك، صار يتحدَّد عبر محاكمة ترمي إلى تحطيم سمو النتاجات لجعلها تطابق بدقة إلغاء التقديس الديمقراطي للهيئة السياسية واختزال العلامات المتأرجحة للسلطة ودنيوية القانون، بحيث توجه نفس العمل إلى «تقزيم» ما هو جليل ورفيع، إلى درجة أن كل المواضيع صارت تعتبر على نفس المستوى، كما أنه صار بإمكان كل العناصر أن تدخل في الإبداعات التشكيلية والأدبية.
وعليه، فإذا كان الفنانون المعاصرون يخدمون مجتمعا ديمقراطيا، فإنهم لا يفعلون ذلك انطلاقا من العمل الصامت الخاص للنظام القديم، بل انطلاقا من مبدأ القطيعة الجذرية والمتطرفة، قطيعة الثوريين السياسيين المعاصرين. لذلك، فإن التماثلات القائمة بين محاكمة ثورية ومحاكمة حداثية هي تماثلات واضحة: إذ أن كل واحدة منها تعني تأسيس قطيعة عنيفة أحادية الاتجاه. وفي هذا الصَّدد، يقول الفنان بول كلي «أريد أن أكون مثل مولود جديد لا أعرف شيئا عن أوروبا إطلاقا..
أريد أن أكون شبه بدائي. وبمعنى آخر، فإن المحاكمتين تؤمنان بنفس الاستثمار المتزايد أو التقديس العلماني للعهد الجديد، وذلك باسم الشعب والمساواة والأمة من جهة، ثم من جهة أخرى، باسم الفن نفسه أو باسم «الإنسان الجديد».
نحن إذن أمام نفس المحاكمات التطرفية ونفس المزايدة الواضحة، سواء على مستوى النظام الإيديولوجي والإرهابي أو على مستوى هوس التوغل في مجالات التجديد الفني. نفس الإرادة الرامية إلى تحدِّي الحدود الوطنية وإضفاء طابع كوني على العالم الجديد (الفن الطبيعي يستعمل أسلوبا عالميا).
نفس التأسيس لجماعات «متقدمة» من المناضلين وفناني الطليعة ولهذا، فإنه ليس بإمكاننا أن نقبل تحليلات «أدورنو» الذي يعتبر الحداثة مجرد نسق تحريري مماثل لمنطق قيمة التبادل الاقتصادية التي تعمل بها الرأسمالية الكبرى، لأن الحداثة ليست نسخا لنظام السلعة، كما أن الثورة الفرنسية لم تكن «ثورة بورجوازية».
وهذا يعني أن النظام الاقتصادي (سواء أدركناه من منظور مصالح الطبقة أو من منظور المنطق التجاري) لا يمكنه أن يجعل المزايدة الحديثة معقولة، ولا أن يفعل نفس الشيء بالنسبة للثورة ضد دين الماضي المتعصب أو التحمس لعظمة المستقبل وبهائه، وإرادة التجديد الجذري.
هذا، ومادامت ميزة الحداثة تقوم على التجديد، فإنها قد أتاحت للفن اتخاذ مسلك آخر يدفع النتاجات الأدبية إلى أن يكون في حالة تناقض مع تناغم الحياة المألوفة من خلال ابتعادها عن تجربتنا المعتادة مع الفضاء واللغة.
المصدر: http://www.balagh.com/thaqafa/410qlyd2.htm
__________________________________________













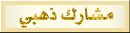



 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس

Bookmarks